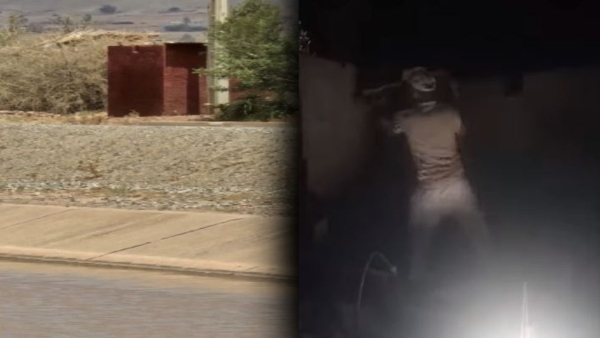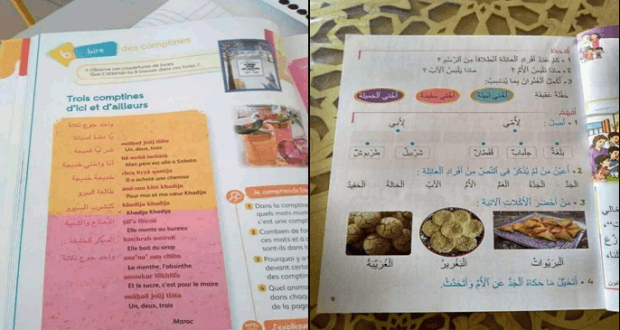
ساحة
العربية وربيباتها من الدوارج
كثر الحديث عن دعوة نور الدين عيوش إلى استعمال الدارجة ضمن المقررات الدراسية ، الامر الذي خلف ردود فعل عديدة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، التي نابت عن المهتمين بالحقل التربوي و المتدخلين فيه سواء جمعيات المدرسين أو النقابات التعليمية التي " ضربتها بسكتة " فضلا عن جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ، و في هذا الصدد ارتأت " كشـ24 " فتح نقاش جدي ، وفسح المجال لجميع المتدخلين وكانت البداية مع مساهمة الاستاذ الباحث شحيمة عبد الصادق .
لمواقع التواصل الاجتماعي في عصر العولمة أفضال لا تعد ولا تحصى،لكن وفي الآن ذاته ،لها من المساوئ ما يتركنا في لحظات عدة نشعر بالامتعاض ،لا لشيء وإنما لسلوكات تتم من طرف بعض المتدخلين أو المدونين لا تحترم من جهة ذوي الاختصاص ومن أخرى تدلي بدلوها في كل ما تموج به فضاءات نقاشاتنا من ملاعب الرياضة بشتى أصنافها ،وصولا إلى قضايا تتسم بعمق نظري وببعد فلسفي وبمفاهيم خاصة دقيقة من غير المجدي أن يخبط فيها خبط عشواء .
وبالرجوع إلى ظاهرة استعمال العامية أو الدارجة أود أن أشير إلى أن النقاش بصددها يعرف المستويات الثلاثة الآتية :
الأول ثقافي/ فكري ولنا فيه مرجعيات لها وزنها وثقلها المعرفي أشير منها على سبيل المثال لا الحصر إلى المرحوم عالم المستقبليات الأستاذ المهدي المنجرة والذي كان قد أشار في إحدى مداخلاته في الموضوع ،إلى أن الاستعمال المكثف للدارجة لم يعد بريئا ،فنحن أمام مخطط يسعى للقضاء على العربية ،وهو المخطط الذي برمج له الاستعمار الفرنسي ،واستمر مع أذنابه حتى الآن .كما أشير إلى الأستاذ المفكر عبد الله العروي وإشارته إلى أن المشكل المرتبط باستعمال الدارجة المغربية لا يطرح إشكالا في السنوات الأولى من التعليم ،وإنما يكمن المشكل في ما يلي تلك السنوات في جميع أسلاكه ،ولتوسيع دائرة استعمالها يدعو إلى تبسيط قواعدها ومعجمها وتركيبها ،مشيرا إلى أن الفرق في الاهتمام بين اللغتين الدارجة والعربية الفصيحة ،هو أن الأخيرة ستدعم من طرف كل الناطقين بها ،في حين أن سابقتها (الدارجة ) لن تحظي بذلك لوجود دوارج عديدة حتى داخل البلد الوحيد بدلا من دارجة واحدة .وللتدليل على ذلك تجدر الإشارة لإلى أن لكل حرفة تقليدية معجم خاص ،يستعصي فهمه على بقية الحرف الأخرى .
المستوى الثاني لغوي محض ،أو لساني معجمي صرف ،وهنا تكون الإمامة لذو الاختصاص ،وبفضل حسن الإصغاء لهم جميعا مع اختلاف مشاربهم ومرجعياتهم يمكن أن نقارب حلولا لمعضلات لغوية كالتي نحن بصددها .وضمن هذا الإطار أشير إلى أساتذتنا الجامعيين الجادين وإلى أساتذة جميع الأسلاك من الذين خبروا هذه اللغة واكتشفوا أسرارها وجماليتها وسحرها ،وغاصوا في أعماقها ،ولا أشك في أنهم سيغنون النقاش ويقلبون أوجهه برؤاهم الثاقبة ونظرهم السديد ،ولأقدم مثالا بالملموس على ما أقول ،فوجئ في إحدى السنوات تلاميذ مستوى الجذع المشترك علوم أثناء قراءة أحد نصوص نجيب محفوظ بكلمة تبدو بالنسبة لهم غريبة كوحدة معجمية فصيحة وهي كلمة حق بضم الحاء ،وفي اللحظة التي طلبت منهم استبدال القاف الوارد في آخر الكلمة بحرف آخر ،وبدأنا في عملية التجريب ،وصلنا إلى حرف الكاف ،وأصبحت الكلمة – حك – بدلا من –حق – واستعرضنا دلالات الكلمة في الدارجة وفي سياقات مختلفة ،وكان هذا مدخلا من مداخل الاستعانة بالدارجة على فهم الفصيحة ،
بل الأعمق من ذلك أن ظاهرة استبدال فونيم بآخر،ظاهرة لغوية عربية قديمة متداولة لدى بعض القبائل أكتفي في التمثيل لها بقبيلة بني سعد المجاورة للفرس والتي كانت لا تنطق الحاء إلا هاء .
أما عن كلمة حق في العربية الفصيحة وهي متعددة ،تبعا لسياقات ورودها،فمرتبطة بدور الأستاذ في ربط المقالات بالمقامات ،إذ لا داعي مثلا لشرح الكلمة بحمولتها الجنسية لتلميذ/ة في السنوات الأولى من تعليمه الابتدائي ،وهو يفتقر لما نسميه حاليا بالتربية الجنسية ،ولا بأس من استعراض المعنى إياه بالنسبة للإعدادي أو الثانوي ،ويستدعي تخصص الطلبة الجامعيين في الآداب أو اللسانيات تعريفهم بمثلث قطرب ،وهنا سيكون الأستاذ باعتماده بيداغوجيا وديداكتيك المادة في جوهر دعوة عبد الله العروي للتبسيط –تحديدا -منه المعجمي .
المستوى الثالث لنقاش الظاهرة بدأ مع بعض المستشرقين منذ نهاية القرن السابع عشر ،واستشرى في لحظات الأمبريالية والاستعمار ،واستفحل مع دعاة الفرنكفونية الحديثة باعتبارها شكلا من أشكال الاستعمار الحديث ،فالمستشرقون كما يشير إلى ذلك محمود محمد الطناحي من أوائل من قسموا اللغة إلى عربية قديمة ،وعربية معاصرة ،وعربية منطوقة أو عامية .
يهمني في هذه المساهمة دعاة الفرانكفونية الحديثة وفي مقدمتهم عيوش ،وأتساءل بداية ما علاقة الرجل بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (من أعطاب التعيينات )باعتباره عضوا كامل العضوية فيه ،وما علاقته باللغة العربية والفكر والثقافة العربيتين ؟
إن جهل الرجل التام ،تركه لا يميز بين اللهجة واللغة ،ولكي يدافع عن أطروحة العامية كلغة للتدريس ،كان من آخر خرجاته المثيرة إشارته أن القرآن نزل بالدارجة ،ولإزالة هذا الغموض واللبس أقول أن كلمة لهجة تطورت في دلالاتها ،فقد كانت تعني في العصر الجاهلي – الحرف- ،واللغويون القدامى كانوا يطلقون اللهجة على اللغة ،وتراثنا اللغوي ملئ بكتب اللغات أي اللهجات ،وهي مؤلفات قد ضاعت من بين ما ضاع من تراث هذه الأمة ،بل إن من عوامل اختلاف القراءات بالإضافة إلى الإعراب ومجموعة من العوامل الأخرى هو اختلاف اللهجات العربية التي نزل بها القرآن ،ولهذا نؤكد أن القرآن لم ينزل بالدارجة وهو كلام عار من المنطق والموضوعية ،وإنما نزل بلهجات القبائل ،وهو موضوع وقع بصدده الاختلاف بين اللغويين يضيق المقام هنا لاستعراضه ،وبناء على ما سبق نتساءل هل يستشعر دعاة الفرانكفونية وكما أشار إلى ذلك عبد الله العروي خطورة ما يدعون إليه ،إننا نبحث عما يوحد هذه الأمة بدلا مما يفرقها ولن يكون في مقدمة ذلك سوى اللغة والفصيحة تحديدا .
شحيمة عبد الصادق
كثر الحديث عن دعوة نور الدين عيوش إلى استعمال الدارجة ضمن المقررات الدراسية ، الامر الذي خلف ردود فعل عديدة ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، التي نابت عن المهتمين بالحقل التربوي و المتدخلين فيه سواء جمعيات المدرسين أو النقابات التعليمية التي " ضربتها بسكتة " فضلا عن جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ، و في هذا الصدد ارتأت " كشـ24 " فتح نقاش جدي ، وفسح المجال لجميع المتدخلين وكانت البداية مع مساهمة الاستاذ الباحث شحيمة عبد الصادق .
لمواقع التواصل الاجتماعي في عصر العولمة أفضال لا تعد ولا تحصى،لكن وفي الآن ذاته ،لها من المساوئ ما يتركنا في لحظات عدة نشعر بالامتعاض ،لا لشيء وإنما لسلوكات تتم من طرف بعض المتدخلين أو المدونين لا تحترم من جهة ذوي الاختصاص ومن أخرى تدلي بدلوها في كل ما تموج به فضاءات نقاشاتنا من ملاعب الرياضة بشتى أصنافها ،وصولا إلى قضايا تتسم بعمق نظري وببعد فلسفي وبمفاهيم خاصة دقيقة من غير المجدي أن يخبط فيها خبط عشواء .
وبالرجوع إلى ظاهرة استعمال العامية أو الدارجة أود أن أشير إلى أن النقاش بصددها يعرف المستويات الثلاثة الآتية :
الأول ثقافي/ فكري ولنا فيه مرجعيات لها وزنها وثقلها المعرفي أشير منها على سبيل المثال لا الحصر إلى المرحوم عالم المستقبليات الأستاذ المهدي المنجرة والذي كان قد أشار في إحدى مداخلاته في الموضوع ،إلى أن الاستعمال المكثف للدارجة لم يعد بريئا ،فنحن أمام مخطط يسعى للقضاء على العربية ،وهو المخطط الذي برمج له الاستعمار الفرنسي ،واستمر مع أذنابه حتى الآن .كما أشير إلى الأستاذ المفكر عبد الله العروي وإشارته إلى أن المشكل المرتبط باستعمال الدارجة المغربية لا يطرح إشكالا في السنوات الأولى من التعليم ،وإنما يكمن المشكل في ما يلي تلك السنوات في جميع أسلاكه ،ولتوسيع دائرة استعمالها يدعو إلى تبسيط قواعدها ومعجمها وتركيبها ،مشيرا إلى أن الفرق في الاهتمام بين اللغتين الدارجة والعربية الفصيحة ،هو أن الأخيرة ستدعم من طرف كل الناطقين بها ،في حين أن سابقتها (الدارجة ) لن تحظي بذلك لوجود دوارج عديدة حتى داخل البلد الوحيد بدلا من دارجة واحدة .وللتدليل على ذلك تجدر الإشارة لإلى أن لكل حرفة تقليدية معجم خاص ،يستعصي فهمه على بقية الحرف الأخرى .
المستوى الثاني لغوي محض ،أو لساني معجمي صرف ،وهنا تكون الإمامة لذو الاختصاص ،وبفضل حسن الإصغاء لهم جميعا مع اختلاف مشاربهم ومرجعياتهم يمكن أن نقارب حلولا لمعضلات لغوية كالتي نحن بصددها .وضمن هذا الإطار أشير إلى أساتذتنا الجامعيين الجادين وإلى أساتذة جميع الأسلاك من الذين خبروا هذه اللغة واكتشفوا أسرارها وجماليتها وسحرها ،وغاصوا في أعماقها ،ولا أشك في أنهم سيغنون النقاش ويقلبون أوجهه برؤاهم الثاقبة ونظرهم السديد ،ولأقدم مثالا بالملموس على ما أقول ،فوجئ في إحدى السنوات تلاميذ مستوى الجذع المشترك علوم أثناء قراءة أحد نصوص نجيب محفوظ بكلمة تبدو بالنسبة لهم غريبة كوحدة معجمية فصيحة وهي كلمة حق بضم الحاء ،وفي اللحظة التي طلبت منهم استبدال القاف الوارد في آخر الكلمة بحرف آخر ،وبدأنا في عملية التجريب ،وصلنا إلى حرف الكاف ،وأصبحت الكلمة – حك – بدلا من –حق – واستعرضنا دلالات الكلمة في الدارجة وفي سياقات مختلفة ،وكان هذا مدخلا من مداخل الاستعانة بالدارجة على فهم الفصيحة ،
بل الأعمق من ذلك أن ظاهرة استبدال فونيم بآخر،ظاهرة لغوية عربية قديمة متداولة لدى بعض القبائل أكتفي في التمثيل لها بقبيلة بني سعد المجاورة للفرس والتي كانت لا تنطق الحاء إلا هاء .
أما عن كلمة حق في العربية الفصيحة وهي متعددة ،تبعا لسياقات ورودها،فمرتبطة بدور الأستاذ في ربط المقالات بالمقامات ،إذ لا داعي مثلا لشرح الكلمة بحمولتها الجنسية لتلميذ/ة في السنوات الأولى من تعليمه الابتدائي ،وهو يفتقر لما نسميه حاليا بالتربية الجنسية ،ولا بأس من استعراض المعنى إياه بالنسبة للإعدادي أو الثانوي ،ويستدعي تخصص الطلبة الجامعيين في الآداب أو اللسانيات تعريفهم بمثلث قطرب ،وهنا سيكون الأستاذ باعتماده بيداغوجيا وديداكتيك المادة في جوهر دعوة عبد الله العروي للتبسيط –تحديدا -منه المعجمي .
المستوى الثالث لنقاش الظاهرة بدأ مع بعض المستشرقين منذ نهاية القرن السابع عشر ،واستشرى في لحظات الأمبريالية والاستعمار ،واستفحل مع دعاة الفرنكفونية الحديثة باعتبارها شكلا من أشكال الاستعمار الحديث ،فالمستشرقون كما يشير إلى ذلك محمود محمد الطناحي من أوائل من قسموا اللغة إلى عربية قديمة ،وعربية معاصرة ،وعربية منطوقة أو عامية .
يهمني في هذه المساهمة دعاة الفرانكفونية الحديثة وفي مقدمتهم عيوش ،وأتساءل بداية ما علاقة الرجل بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (من أعطاب التعيينات )باعتباره عضوا كامل العضوية فيه ،وما علاقته باللغة العربية والفكر والثقافة العربيتين ؟
إن جهل الرجل التام ،تركه لا يميز بين اللهجة واللغة ،ولكي يدافع عن أطروحة العامية كلغة للتدريس ،كان من آخر خرجاته المثيرة إشارته أن القرآن نزل بالدارجة ،ولإزالة هذا الغموض واللبس أقول أن كلمة لهجة تطورت في دلالاتها ،فقد كانت تعني في العصر الجاهلي – الحرف- ،واللغويون القدامى كانوا يطلقون اللهجة على اللغة ،وتراثنا اللغوي ملئ بكتب اللغات أي اللهجات ،وهي مؤلفات قد ضاعت من بين ما ضاع من تراث هذه الأمة ،بل إن من عوامل اختلاف القراءات بالإضافة إلى الإعراب ومجموعة من العوامل الأخرى هو اختلاف اللهجات العربية التي نزل بها القرآن ،ولهذا نؤكد أن القرآن لم ينزل بالدارجة وهو كلام عار من المنطق والموضوعية ،وإنما نزل بلهجات القبائل ،وهو موضوع وقع بصدده الاختلاف بين اللغويين يضيق المقام هنا لاستعراضه ،وبناء على ما سبق نتساءل هل يستشعر دعاة الفرانكفونية وكما أشار إلى ذلك عبد الله العروي خطورة ما يدعون إليه ،إننا نبحث عما يوحد هذه الأمة بدلا مما يفرقها ولن يكون في مقدمة ذلك سوى اللغة والفصيحة تحديدا .
شحيمة عبد الصادق
ملصقات
ساحة

ساحة

ساحة

ساحة